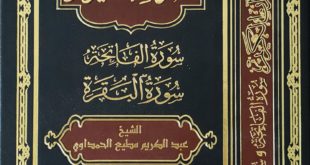موقفنا من موضوع التنمية الذي عينت له لجنة وطنية خاصة
فرض موضوع التنمية نفسه في المغرب على الصعيد الواقعي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتدبيريا، بحدة تداعت لها أركان النظام فاضطر بها إلى تشكيل لجنة رسمية على رأسها الأستاذ شكيب بن موسى، للبحث عن حلول ناجعة ووضع أنموذج تنموي ينقذ المغرب من كارثة مرتقبة كما يذهب إلى ذلك المراقبون، وإلى استمزاج آراء بعض التنظيمات السياسية والشخصيات ذات الاهتمام بالشأن العام لمعرفة تصوراتها واقتراحاتها لما يمكن أن يسهم في تصور خارطة طريق للخروج الآمن من هذه الأزمة حسب أقوال أصحاب هذه الدعوة.
لكن السؤال المشروع لكل ملاحظ هو: لماذا الحديث عن التنمية في ذلك الوقت؟ وما دوافعه، وضروراته، وهل للمغرب والمغاربة حاجة إليه، وما جدواه أو الفائدة منه؟ وهل الداعون إلى تأسيس أنموذج تنموي جادون في سعيهم ومدركون لشروطه ومقتضياته؟ ولماذا تراجع هذا الحديث إن لم يكد ينعدم بعد أزمة كورونا وما صاحبها من إجراءات استثنائية؟
قبل مناقشة هذه القضايا ينبغي معرفة المقصود بمصطلح التنمية، في اللغة وفي الاستخدام الاصطلاحي:
فالتنمية لغةً مشتقة من كلمة نما، وتعني الزيادة والانتشار والتطور.
والمفهوم الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ لأن المقصود بالتنمية: هو عملية نهوض المجتمع وتطوره، بها ومن خلالها تتحقق حياة كريمة ومستقرة لأفراده في المجالات كلها.
ولعل ما يميز هذا المصطلح أنه مفهوم شامل، موضوعه وجوهره الإنسان؛ لذلك اكتسب خصائصه منه، وأهمها أن التنمية عملية حيوية لا تقبل السكون أو الجمود، إن لم تتقدم إلى الأمام تراجعت إلى الوراء، وهي تتطلب حتما رؤية وتصورا وتخطيطا وعملا وجهدا دائبا للحفاظ على حيويتها وديمومتها، حتى لا تكون عملا ارتجاليا مؤقتا، لا يجدي نفعا ولا يحقق هدفا ولا يقود إلى غاية.
مرتكز التنمية هو الإنسان أفراداً وجماعاتٍ، والبلدان النامية حقاً – أي المتقدمة والمتطورة على اختلاف اختياراتها – هي التي تضع الإنسان في بؤرة اهتمامها، تُؤَمِّن له الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، سعياً لتحقيق شروط حياة كريمة. وهي لذلك تحدد أهدافاً، وتضع تصورات وتطبق سياسات لتبلغ تلك الأهداف.
إن أولى مرامي التنمية أن يوفر المجتمع لأعضائه كل حاجاتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال توفير فرص كسب وتعليم وعلاج، وترسيخ الحق في المشاركة في الشأن العام قرارا ومراقبة ومحاسبة وحرية رأي وشعورا بالأمن على النفس والأهل والمجال الخاص.
إنه ليس هناك أنموذج متفق عليه تقاس به التنمية، ولكن نجاح أي مجتمع في تحقيق غايته الكبرى من الاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي والتطور العلمي والأمن الاجتماعي والسيادة الوطنية، وتوفير كل الظروف المناسبة لتطوير مهارات الأفراد والجماعات ورعايتها قد يمثل أنموذجا للتنمية، يمكن الاستفادة منه والسير على منواله والقياس عليه.
وما لم يكن للحاكم إرادة حقيقية لبلوغ التنمية، وما لم تترجم هذه الإرادة في رؤية وتصور وأهداف واضحة، وقيام بالتخطيط والعمل لتحقيقها على أرض الواقع، فإن الحديث عن أنموذج تنموي يظل لغواً وعبثاً.
إن أولى ركائز التنمية وجود نظام سياسي مستقر واقتصاد قوي متطور، وهما أمران مترابطان ترابطا عضويا متينا؛ تمتد آثارهما إلى كل مجالات المجتمع الحيوية. والحديث عن الاستقرار السياسي يستلزم مناقشة النظام السياسي نفسه، طبيعته وتركيبته وشرعيته وآليات التسيير والمراقبة فيه، إذ لا بد أن تكون العلاقات بين المؤسسات السياسية واضحة ومتفقا عليها، ومن بيده السلطة والنفوذ يستند إلى شرعية المجتمع من خلال تعاقد اجتماعي رضائي، يسهم في التفاف الناس حوله، وتوحدهم معه حول المبادئ والأهداف الكبرى.
هذا أول منعطف تختبر فيه مصداقية الحاكم وجديته فيما يرفعه من شعارات وما يدعو إليه من مشاريع، والسؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه: هل هو مستعد للقبول بنظام سياسي يتوافق عليه المجتمع ويكون فيه الاعتبار في تولي المسؤوليات وتوزيعها للكفاءة العلمية والقدرة على العمل والتنفيذ وقبول المحاسبة والمراقبة والحفاظ على الحقوق العامة للمجتمع بمعتقداته وثوابته ومؤسساته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
إن أغلب الدول التي تعد ضمن العالم المتقدم والمتطور قد انطلقت في مسيرة تنميتها من أوضاع أسوأ بكثير مما يعيشه المغرب اليوم، واستطاعت برغم كل الصعوبات أن تحقق إنجازات كبرى في مجالات تنموية مختلفة، والأمثلة على ذلك متعددة سواء في أوربا أو آسيا. ولئن كنا نتحدث هنا عن التنمية في بعض صورها العامة، فإننا لسنا بصدد إصدار أحكام قيمية عن التنمية؛ لأن الأمة هي التي لها أن تضع تصوراتها الخاصة بالتنمية في معناها الشامل وحسب حاجاتها، وأن تحدد أهدافها ووسائلها وتسعى إلى تحقيقها بتوظيف كل طاقاتها البشرية والمادية والمعنوية.
فهل النظام المغربي جاد في حديثه عن التنمية؟ ولِمَاذا اضطر للاعتراف بفشله في هذا الميدان؟ أم أن الأمر مجرد توظيف آني للموضوع من أجل تجاوز ظروف آنية يعود بعدها إلى ما كان عليه.
الجواب عن هذه الأسئلة يقتضي حتماً معرفة بالسياقات التاريخية للنظامين السياسي والاقتصادي ومدى تأثرهما وتأثيرهما في الحياة الاجتماعية سواء في فترة الحماية الفرنسية أو فيما تلاها؛ ذلك أن طبيعة النظام المغربي قبل الحماية المعروف بنظام “المخزن” لم يفلح في مسايرة التطورات التي شهدها العصر، ولم يمتلك من المناعة الذاتية ما يجابه به غضب الداخل وأطماع الخارج، فوقع تحت السلطة المباشرة للحكم الفرنسي الذي طوّع النظام المخزني بما يخدم مصالح فرنسا الاستعمارية.
لقد أثارت السيطرة المباشرة لفرنسا على المغرب غضب القوى الوطنية وثورتها، فلجأت إلى المقاومة المسلحة التي آل أمرها إلى خدمة النظام المخزني وحده وتثبيت أركانه وحده، فلم تلتق بذلك رؤيته ومصالحه برؤية الشعب المغربي ومصالحه، وبقيت العلاقة بين الطرفين مشوبة بكثير من التوجس وعدم الثقة، تخللتها أحيانا مظاهر صدام دام ومؤسف انعكس على استقرار الحياة السياسية وتطورها.
هذه العلاقة السلبية التي حكمت الطرفين ظلت تطبع الأحوال السياسية في المغرب إلى وقتنا الحاضر، ولعل كنه الأزمة لا يقتصر على عدم امتلاك كل الأطراف لتصور واضح لطبيعة نظام سياسي يمكن التوافق حوله، وإنما الأمر يتجاوز ذلك، فالنظام السياسي القائم في الواقع لم يتطور ذاتيا ولم يفسح المجال لتطوير المجتمع، فظلت الأوضاع العامة لذلك غير مريحة للطرفين، وكان للمستعمر السابق دور رئيس في تشكيل هذه الحالة، حيث حرص على خدمة مصالحه على حساب مصالح المغرب وتطوره، أما الأطراف السياسية التي شكلت محور المقاومة، فلم تكن أيضا على قلب رجل واحد؛ إذْ تجاذبتها تيارات ومشارب ذات تصورات متباينة، فلجـأ المخزن إلى أساليب الترغيب والترهيب والتزعيم والتقسيم والتقزيم والتصفية من أجل رسم واقع جديد يتم به التحكم في الجميع، بأقسى أساليب الاستبداد، فنتج عن كل هذا استنزاف لطاقات وإهدار لقدرات بشرية ومادية كثيرة.
إن صلب الإشكال في الحياة السياسية المغربية يكمن في انعدام الرؤية المشتركة للنظام السياسي الحاكم مع الشعب المحكوم، وغياب رؤية مشتركة يتوافق عليها المغاربة، وفي إطارها ومن خلالها يسهمون في التنمية والتطوير؛ لأن نظام “المخزنة” الذي ورثه النظام الحالي صيغة قديمة أقرب إلى نظام الإقطاع، لم تتطور ولم تساير المتغيرات الدولية المعاصرة أو تتأثر بها، إلا في بعض شكليات ومظاهر لم تغير جوهره وطبيعته، وبقي بذلك نظاما هجينا لا هو بالقديم ولا هو بالمساير لمتغيرات العصر.
لقد لجأ المخزن المتوجس من السياسيين دائما إلى تركيز كل جهوده في هدفين رئيسين:
1- ضمان استمرار وجوده وديمومته واختزال مفهوم الدولة فيه.
2- الاستئثار بالسلطة والمال لضمان هذه الاستمرارية والديمومة.
ولأن المخزن اختزل الدولة في نفسه، فإنه لم يقبل بأي تنظيم سياسي يعده منافسا له أو مهدداً لشرعيته، فركز كل جهوده لتطويع الأحزاب والتنظيمات، بل لجأ إلى استصناع ما عُرف بالأحزاب الإدارية لتضفي مسحة ديموقراطية على المشهد السياسي ولتُحْكِم سيطرتها عليه. واعتمد أساليبه المخزنية القديمة في شراء الولاءات بمنح الأعطيات والهبات والتراخيص، وفي إبعاد من يعدهم خصوما بشتى الطرق توظيفا للقضاء واستخداما للأجهزة الأمنية والإعلامية تشويها واعتقالا ونفيا.
ولعل أكبر تناقض وقع فيه المخزن أنه احتكر السلطة السياسية لنفسه، ولكنه لم يعترف بمسؤوليته عنها أو عن الأزمات التي أنتجتها خياراته فيها وكانت سببا مباشراً لممارساته فيها، بل حمل هذه المسؤولية غالبا لأحزاب اصطنعها أو كان وراء تمزيقها وشرذمتها، أو ألقى باللوم على عامة الشعب لسلبيته وعدم حماسه للعمل السياسي والمشاركة فيه، وهذا ما يفسر التعثر المستمر والفشل الملازم غالبا لكثير من المبادرات السياسية والمشاريع الاقتصادية؛ إذْ لا يمكن أن تستفرد بكل السلطات الحقيقية ثم تلوم عموم الشعب على عدم حماسته للسياسة، ولا يعقل أن تحتكر جل الثروات ثم تتساءل: أين الثروة؟ لن يشعر أي إنسان سَوِيٍّ إذاك بجدية هذا الخطاب.
الحديث عن السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة وأمن النفوس والأعراض وعن التنمية محكم الترابط، والسؤال عن التنمية في مجمل هذه المجالات يبقى بدون جواب ما لم يفكر في برنامج متكامل لمعالجة هذه الحالات كلها معالجة متكاملة، ولكن قبل الجواب ينبغي أن نسأل عن أي نظام لدينا الآن، وهل هو نظام حقاً، أم تركيبة هجينة لا يمكن نسبتها إلى أي نظام ؟ كيف تم تشكيله ووضعه؟ هل له أهداف وغايات وطنية عامة؟ وإذا وجدت ففي خدمة أي جهة هي؟ ما هي ثروات البلاد وأين مصادرها؟ كيف توظف هذه الثروات وما هي مصارفها؟ هل هي لخدمة فئة معينة داخلية أو خارجية أو في خدمة الأمة وشأنها العام؟ من يقوم بالمراقبة والمحاسبة على اتخاذ قرارات الشأن العام وتوظيف المال العام وطرق استثماره؟ وأي مشروع اقتصادي يندرج في الأهداف الاستراتيجية للدولة؟ وأي مشروع هو مجرد خدمة لمصالح أجنبية أو فردية؟ كيف يتم تنظيم العلاقة بين السياسة والاقتصاد؟ وبينهما وبين برامج التعليم والتطبيب، وهل يسمح للسياسي ومسؤول الشأن العام بأن يشتغل بجمع المال واستثماره وتوظيفه؟ كيف تمول التنظيمات السياسية؟ من يستفيد من الهبات والأعطيات ومختلف تراخيص الاستغلال والاستثمار؟ وهل نظام الهبات والأعطيات المخزنية ما زال صالحا لدولة حديثة متطورة نامية أو لوضع اقتصادي مترد يعيشه المغرب حاليا؟
إن طرح أي تصورات لنظام اقتصادي يخدم التنمية مهما كان نوعه أو أهدافه دون وجود إرادة سياسية حقيقية وفعلية وعزيمة صادقة وشفافية واضحة يظل عملا غير مثمر، لا نجني منه إلا مزيد إهدار للجهود والطاقات، وعبثا ينبغي أن تصان عنه أفعال العقلاء، ولن يكون مصيره مهما كانت برامجه علمية أو عملية أو مثالية إلا الأدراج المهملة المنسية.
وعندما تتوفر الإرادة وتحدد الأهداف ويُختار ما يناسب من الوسائل، يمكن الاطمئنان إلى أننا في الطريق الصحيح، غير أن هذا كله يظل مفتقرا إلى ضمان الأمن والثقة بين عامة الشعب وجهاز تدبير الشأن العام، ولن يتحقق ذلك إلا بنظام قضائي نزيه يطمئن فيه المواطن والمواطنة والمسؤول والحزب والجمعية والمؤسسة على أن الكل سواسية أمام القانون، وأن القوانين في تطبيقها لا تميز بين المواطنين، من أسفل القاعدة إلى رأس الهرم، لا أحد يمكن أن يستغل منصبه أو سلطته مهما علت في مأرب شخصي أو تصفية حساب، هذا النظام القضائي الذي يعامل فيه كل مسؤول بالمعايير نفسها، والذي به ما يكفي من الضمانات لكسب ثقة المواطن هو المحفز الأكبر لتعاون الجميع على اختلاف مشاربهم في السياسة والاقتصاد وتطوير المجتمع، وتحقيق التنمية المنشودة.
وفي ارتباط وثيق مع هذه المجالات الثلاث يمثل الإعلام والصحافة واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي علامة مميزة لمستوى حرية التعبير وأداة فعالة لممارسة الرقابة على السلطات، ووسيلة مهمة لتطوير النقاش السياسي والاجتماعي والفكري في المجتمع.
ولعل ما يعانيه هذا المجال هو عينه ما شهده ميدان السياسة، وكما أن الحياة الحزبية تم التحكم فيها بشكل فظ ومكشوف في أحيان كثيرة، فإن المجال الإعلامي لم يسلم من هذه العاهات، بل إن التحكم في الساحة الإعلامية كان أشد وأقوى، حيث ظلت معاهد الإعلام والاتصال لسنوات تحت إشراف مباشر لوزارة الداخلية المعروفة تاريخيا بــ”وزارة السيادة”، فرأينا في كثير من الأحيان تداخلا تاما بين صفتي الصحفي ورجل الأمن أو المخبر. أما ما بقي من الصحافة المستقلة، فإنه تم التضييق عليها ومحاربتها بخنقها ماليا أو إقحامها في دهاليز المحاكم التي تصدر شهادات الوفاة في حقها أو قرارات الاعتقال أو التهجير في حق العاملين بها.
وبعد أن فقدت وسائل الإعلام التقليدية تأثيرها وكثيرا من مصداقيتها سواء أكانت صحافة ورقية أم قنوات فضائية، هجرها عامة الناس وخاصتهم إلى وسائط التواصل الاجتماعي التي أضحت أكثر تأثيراً وأوسع انتشاراً وأكثر جلباً لاهتمام مختلف الشرائح الاجتماعية. وهذا ما دفع السلطة إلى محاولة ضبط هذا المجال والتحكم فيه بإصدار الضوابط والقوانين، والتهديد بالعقوبات الحبسية والغرامات المالية للناشطين فيه.
إن هذا الوضع غير الصحي لميدان الإعلام والصحافة مرتبط ارتباطا عضويا بغيره من المجالات الحيوية في المجتمع المغربي سياسةً واقتصاداً ونظاماً قضائياً، وما لم يتم إعادة النظر في هذه المجالات كلها بمنهج نقدي بناء ومتكامل، سيظل الحديث عن التنمية غير ذي جدوى، وتغدو أغلب الجهود للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتطويرها بلا مردود ولا فائدة.
عندما تتحقق الإرادة السياسية لبناء نظام سياسي يتيح المشاركة الحقيقية لكل الشركاء في الوطن، وتجتمع مختلف الرؤى والتصورات لوضع نظام اقتصادي يكون هدفه الارتقاء بحياة الناس أفراداً ومؤسسات، وتحسين جودة حياتهم، وعندما يثق الناس في نظام عدالتهم ويطمئنون إليه، ويأمنون على أنفسهم أثناء التعبير عن آرائهم، وتتساوى فرصهم في الكسب وتولي المناصب وتحمل المسؤوليات والخضوع للمساءلة؛ إذاك يلمسون صدق الشعارات ويسهمون في التنمية الحقيقية التي تحترم آدميتهم، وتعطي معنى لوجودهم في بلدهم.
إعداد
د. حسن بكير
الأمين العام للحركة الإسلامية المغربية (الأم)
الاثنين 16 شوال 1441 هجرية (08/يونيو/ 2020)
 الحركة الحركة الإسلامية المغربية
الحركة الحركة الإسلامية المغربية